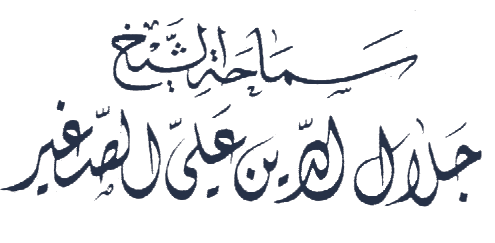بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين وعلى الهداة المهديين من اله الطاهرين لا سيما بقية الله في الارضين الامام المهدي المنتظر ارواحنا له الفدا.
ما أن تم الإعلان عن نتائج التصويت على قانون الإنتخابات حتى أمكن ملاحظة اتجاهين عامين في الأوساط السياسية، فمنهم من ابتهج واحتفل بالنصر واعتبر ذلك بمثابة انتصار مبكر في الانتخابات القادمة، ولم تني بعض الأطراف الاخرى من المباركة لجمهورها بتحقق المطالب الشعبية، فيما يمكن ملاحظة مشاعر الانتكاس والاحباط في اتجاهات اخرى.
وبعيداً عن الحكم لهذا الإتجاه أو ذاك، ينبغي التعامل بحذر بالغ مع مواضيع من هذا القبيل، فالقانون الإنتخابي لا يمكن أن يصنف على البيئة القانونية البحتة، كما أنه لا يمكن أن يكون مادة للتسويق الجماهيري، وإنما هو خليط من عمليات فنية وإدارية وأمنية معقدة للغاية، ولا يخلو في نفس الوقت من ارتباط وثيق الصلة بالبنية الأمنية العامة للبلد، فهو محور العلاقة بين الشرعية والسلطة، وأي مساس في هذه المحورية قد يفضي لفتح أبواب غير محمودة على الامن المجتمعي برمته، ولهذا يجب أن تناقش نزاهته في بيئة بعيدة عن الصخب وبعقل بارد، وهنا يمكن تسجيل أول خلل على طبيعة عملية الاقتراع عليه، لأن العملية جرت تحت ضغوط متعددة، ولم يفت المتابع أن جانباً من عملية التصويت عليه كانت الى الاستجابة لهذه الضغوط أكثر مما هي إستجابة إلى متطلبات النزاهة والعدالة، ولهذا ربما كان ما فاز به فريق اليوم هو ذاته الذي سيؤسس لتمرد مستقبلي وعرقلة من الفريق المضاد في الغد.
ومع ملاحظة اني لن اناقش في هذه الورقة الملاحظات الفنية على القانون وهي كثيرة جداً، ولكن سيكون جلّ كلامي مركز على البيئة العامة التي ستحيط بتنفيذ وإجراء العملية الإنتخابية وفق هذا القانون، علّها ترينا الصورة الحقيقية لما ستجري عليه الأمور والتي قد تعطينا المجال لتلافي الخلل الذي قد يصيب شفافية ونزاهة عملية الاجراء هذه، وهي ملاحظات بموجبها ربما نستطيع أن نقيّم الأمور بشكل دقيق:
أولاً: من الفوارق الأساسية بين السياسي والقانوني أن القانوني يفكر بطبيعة تجريدية للنصوص القانونية، ويتعامل مع النصوص بعنوانها قالباً تترابط فيه فلسفة النص مع الطبيعة اللفظية للنص، بينما السياسي يفكر في العادة بآليات التطبيق وكيفيته ومداخل ذلك ومخارجه وكذلك بالروافد الاجتماعية التي سينتهي اليها تطبيق النص، فالسارق والسارقة -كنص تشريعي- يتعامل معه القانوني بالنظر الى قضية السرقة نفسها، ولا يهتم بطبيعة الظرف الإجتماعي للسرقة فما يهمّه هو موضوع الجريمة والجزاء، بينما السياسي تراه ينظر إلى أبعد من ذلك فيجد أن الظرف الاجتماعي للسرقة يتحكم في طبيعة الجزاء، ولذلك رفض أمير المؤمنين عليه السلام في زمن عمر إيقاع عقوبة السرقة حينما وقعت في زمن الجوع، إذ أعطى للجوع قيمة عطلت الجزاء القانوني لصالح السارق الجائع الذي سرق بسبب جوعه، كما رفض الاكتفاء بايقاع العقوبة القانونية على محتس للخمر في شهر رمضان، وإنما طالب بإضافة بعد حرمة شهر رمضان كحيثية إضافية يجب أن تضاف للتعزير المنصوص على السرقة، ولهذا عزّر النجاشي الشاعر مرتين مرة لشرب الخمر وأخرى لجرأته على الله في شهر رمضان.
ولهذا فان أردنا أن نحاسب القانون ضمن صيغه اللغوية والقانونية وبشكل مجرد عن طبيعة الظرف الاجتماعي فقد نجد واحة من العدالة، ولكن حالما تنظر إلى القانون من خلال بيئته الاجتماعية والسياسية ستجد السر الذي يجعل فريقاً يبتهج ويحتفل مبكراً بأن الحكومة القادمة ستكون بيده، ويجعل أطرافاً اخرى تبتأس بخلاف ذلك، وهذا الاحتفال وذاك الابتئاس يعود في واقع الأمر لرؤية السياسي لكيفية إسقاط النص القانوني على البيئة الاجتماعية والسياسية، وطبيعة ما تتيحه هذه البيئة من فرص لهذا أن يتلاعب ويزوّر ويستخدم النص القانوني كي يمارس كل الألاعيب المتاحة لديه من خلال قوته السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ولذاك في أن يعاني ويكابد الأمّرين، لان إمكاناته السياسية والأمنية والأخلاقية و و والخ تقصر أن تصل الى إمكانات مناورة الطرف الأول، مثلها بالضبط مثل تعامل الصادق والكاذب والأمين والخائن مع الَقسَم القانوني، اذ طالما رددنا المثل الشعبي الذي يتحدث عن أن السارق حينما قال له القاضي: أقسم! فإنه سرعان ما بشّر نفسه بحصول الفرج.
إن مشكلة القانون تكمن في تصوري- مع تجاوز مشاكله الفنية والقانونية وهي كثيرة جداً - ليست في تركيبته اللفظية والنصية، إذ يمكن القول أن نسب العدالة فيه جيدة ولا تقل عن بقية القوانين، إن لم تتفوق عليها، ولكن مشكلته الحقيقية في بيئته التطبيقية السياسية والاجتماعية.
ولكن كل ذلك لا يعني القول أنه لا يعاني في ناحيته الفنية والدستورية من إشكالات جوهرية، فثمة خروقات في داخله يجب أن تراقب بدقة لاسيما في التوافق مع الدستور في حصة المائة الف لكل مقعد، وكيفية احتسابها من الناحية العملية وليس النظرية الرقمية كما قد يعمد اليه البعض، وكذلك في قصص الدوائر الانتخابية لاسيما في الأقضية المتنازع عليها، وفي الأقضية غير الرسمية، وفي الأقضية التي لا يقصر سكانها عن نصاب المائة ألف مواطن الدستوري، وما سيأتي من أمور قد توضح في الملحق المرتقب للقانون أو قد تزداد غموضاً معه، ولا أجد في هذا المقال مجالاً للتطرق إليها بشكل تفصيلي، ولكن أحببت أن أنوّه عنها.
ثانياً: مع التسالم على أن القوانين يجب أن تحقق رقعة متساوية أمام الجميع للإستفادة منها، ولكن ما تنطوي عليه البيئة المحيطة بالقانون من الناحية الواقعية سيلعب دوراً جوهرياً في سلب المصداقيةعن مبدأ تكافؤ الفرص التي يفترض بأي قانون أن يوفرها، وبالتالي فإن هذه البيئة سوف تحدد سلفاً الجهة التي ستستفيد والجهة التي ستحرم، وهنا اسمحوا لي أن أشير إلى الأمور التالية على سبيل التمثيل لا الحصر:
أ: أخطر استفادة من البيئة الحالية للقانون ستكون من قبل الجهات التي تجد الفرصة للتلاعب بالقانون وانتهاك بقية القوانين، فالقانون بحد ذاته يسمح لانتهاكات كثيرة، ومثله الجهاز الذي يشرف عليه - وأعني المفوضية -، وكذلك الشأن بالنسبة للأجهزة الضابطة له ابتداءاً من البطاقات التعريفية وتحديد الدوائر الإنتخابية وقوائم الشطب وما إلى ذلك، مروراً بالأجهزة الأمنية التي يفترض أنها تشرف على سلاسة الإنتخابات، ووصولاً الى شؤون الصناديق الإنتخابية، وتجربة الإنتخابات السابقة تتحدث أن كل واحدة من هذه الأمور وغيرها كانت عرضة لانتهاكات صارخة في وقت كانت الأوضاع العامة لبيئة حفظ القوانين أكثر قوة مما هي عليه الآن، فما بالك بما يجري الان وسيجري في الغد؟ إذ من الواضح أن الأجواء التحريضية السائدة وأجواء الاحتجاجات الحالية قد تسببت بأكبر ضرر ممكن أحدق بهيبة الدولة وأجهزتها الأمنية.
ب: لقد أعطى القانون دوراً جوهرياً للأمم المتحدة في داخل العملية الإنتخابية، وما كان الأمر ليشكل مشكلة لو اكتفى القانون بالتأكيد على إشراف الأمم المتحدة على نزاهة الانتخابات وشفافية الإجراءات المتعلقة بها، فهذا أمر حسن في نفسه، ولكن اشتراك الأمم المتحدة في العملية الإدارية للانتخابات، سيعيدنا حتما إلى سياساتها السابقة غير النزيهة في التحكم بنتائج الإنتخابات، وسيعيد لنا في الغالب الأيادي الأمريكية والإسرائيلية التي تخفّت تحت يافطة خبراء الأمم المتحدة تارة عبر برامج التحكم بالداتا الانتخابية والأجهزة الختامية في عدّ الأصوات ألكترونياً، وأخرى عبر التحكم الرقابي وأمثالها من العمليات، وقصصها في هذا المجال كثيرة جداً يعرفها أهل الإختصاص، ولئن لاحظنا عدم حيادية الأمم المتحدة في تقرير بيلاسخارت للمجتمع الأممي في رسم صورة الأحداث الأخيرة، فإن الشك في طبيعة عدم حياديتها ونزاهتها في التعامل مع القضية الانتخابية أولى لا سيما لو شفّعنا ذلك بالتجارب السابقة.
ج: ما يلاحظ أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بشأن المفوضية المستقلة للإنتخابات، وإن أطاحت بجزء أساسي من المتحكّمين بفسادها وعدم نزاهتها، من خلال التخلص من كوادرها القيادية الأولى والثانية، غير أنها أبقت العناصر الوسيطة الميدانية التي تمثل الجهاز الفني والتنفيذي للفساد والتزوير. وبالنتيجة فالبيئة الذاتية للفساد وعدم النزاهة لا زالت تتمتع بوجود أساسي للتحكم بالقانون وتنفيذه.
د: إن استبدال المفوضين السابقين بقضاة لن يساهم بشكل جاد بعملية النزاهة والحيادية المطلوبة، وإنما سيضيف عنصراً جديداً من عناصر تصعيب مهمة النزاهة والحيادية، فالعمل الإنتخابي عملاً فنياً معقداً لا علاقة له بالبنية القضائية أبداً، والوصول إلى الخبرة فيه والإلتفات إلى فذلكاته والتنبّه لنكاته الدقيقة تحتاج إلى خبرة خاصة في باب الإنتخابات لا توفرها البنية القضائية، ومع كون استبدال المفوضين السابقين ومن بعدهم كان عملاً مطلوباً في نفسه لإبعاد التوجهات الحزبية التي سيطرت بغير حق على مفوضية يفترض أن تكون مستقلة غير أن استبدال الجهاز الذي تمرس على الخبرة الفنية، بآخر لا خبرة فيه، هو عمل لا ينم عن حرص على الإنجاز المتقن، ومع أن هذه الخبرة يمكن للقضاة الجدد أن يتوفروا عليها من خلال الدورات التعليمية الخاصة التي يجب أن يدخلوا فيها، وهي بالعشرات، ولكني أخشى وبجدية متناهية بناءاً على التجربة الميدانية السابقة أن يتم اختزال ذلك بحجج ضيق الوقت وما إلى ذلك لتنتج عملية سلق لإجراءات النزاهة والحيادية والدقة والشفافية.
ها: من الواضح للعيان أن الإحتجاجات الحالية أظهرت تحريضاً اقليمياً ودولياً واسع النطاق يعضده طابوراً داخلياً سار على نفس المنوال تجاه فريق سياسي محدد، وقد أظهرت الإجراءات الحكومية عجزها عن التصدي لهذا التحريض، مما سيظهر الحيادية في العملية الدعائية الإنتخابية مشروخة سلفاً.
هذه أمثلة ليست حصرية على طبيعة العوامل التي سبق أن أدّت إلى المساس بنزاهة الانتخابات، والتي استشعر انها ستلازم عملية الانتخابات القادمة، وما لم تجابه بمعالجات جادة فإن الحديث عن حلول جذرية لمأزق الحيادية والنزاهة الانتخابية سيكون أمراً مخادعاً، وفي أحسن الأحوال سيكون منطوياً على المبالغة المفرطة، وعندها فإن الحديث عن تكافؤ الفرص سيكون مشروخاً بشكل كبير.
ثالثاً: إن حيادية الإنتخابات تحتاج الى أجواء أمنية واجتماعية ملائمة تمكّن عقل الناخب من الوصول الى اختيار سليم لممثليه في الإنتخابات، وحيث أن القانون طرح في خضمأاوضاع انتهكت هذه الأجواء بطريقة فاحشة جداً، ولذلك الحديث عن الفرص المتساوية التي يؤسس لها القانون سيكون حديثاً جميلاً، ولكنه في واقع الحال منقوض الأطراف ومهلهل المحتوى، واعتقد أن العمل على إيجاد الأجواء الأمنية والاجتماعية المناسبة هو الذي يجب أن يوضع كأولوية وطنية لازمة، قبل أن نطلق الزغاريد عن السلامة الوطنية للانتخابات القادمة، فعن أي سلامة يمكننا أن نتحدث؟ إن كانت المراكز الإنتخابية بموظفيها ومراقبيها وكذلك من يرتادها من الناخبين يمر بإجراءات التهديد والوعيد التي تسلّطها العصابات والتي قد تغلف نفسها بهذا الغطاء أو ذاك، ولعل العجز الذي نراه في قبال حفظ الدوام في مدرسة من أن تحرق من قبل نفس هذه العصابات والتي لا شك أن بنيتها السياسية ستشارك في الإنتخابات، يقدم دليلاً لا يستهان به إلى خطورة هذا العامل الذي قد يحوّل الإنتخابات إلى مكمن خطر على الأمن المجتمعي بدلاً من أن تسهم بالتداول السلمي للسلطة.
رابعاً: إن العملية الإنتخابية تنطوي على أبعاد حاسمة في مسارات الشعوب، لكونها تنظّم العلاقة بين الشرعية والسلطة، وكلما كانت أوضاع الشعوب تعاني من عدم الإستقرار ومن تحكّم العوامل المزاجية فيها، فإن أبعادها ستكتسب خطورة بالغة وقصوى قد تؤدي الى ظواهر إنقلابية مضادة، ولذلك من دون توافر الوعي العام بطبيعتها، وتحمّل النخب الواعية والمخلصة مسؤوليتها الكبرى بشكل خاص في هذا المجال، فإن الحديث عن عظمة هذا القانون أو ذاك سيكون ضرباً من الخيال.
خيارات النخبة الصالحة
وحتى لا يكون الحديث عن النخب الواعية حديثاً فضفاضاً لا محتوى حقيقي له، فان التفكير بنجاحات إنتخابية في مجال إنتخاب صفوة وطنية مخلصة لقيادة البلد يحتاج إلى عدة عوامل أهمها:
أ: توفر المشروع الوطني المخلص الذي له معالم محددة، ومسارب تنفيذية عملية وواقعية.
ب: النخبة الصالحة القادرة على تحويل هذا المشروع إلى واقع تنفيذي، والتي تتحمل المسؤولية الكاملة وتوفّر التضحية المطلوبة وتؤمِّن المثابرة المستديمة لذلك.
ج: القاعدة الجماهيرية التي تحمي النخبة الصالحة وتعمل على إيصالها الى سدّة المسؤولية، بما يعني ذلك من المشاركة الواسعة في الإنتخابات، والدقة في خيارات التصويتات بما يتناسب مع متطلبات الدوائر الانتخابية وفق القانون الجديد.
د: توفير الآليات الرقابية والتنظيمية والإدارية والإعلامية التي تجمع ما بين الصوت الجماهيري والنخبة الصالحة، ولا نعني بذلك العملية الإدارية التي تمارسها دوائر المفوضية، وإنما نعني به الدور الجماهيري الذي يراقب الأداء ويثابر للحفاظ على الصوت الانتخابي من أول ولادته إن صح التعبير مروراً بتدوينه ووصولاً إلى حين تسجيله في الوثائق الرسمية.
خيارات المستقلين
غير أن كل ذلك يجب أن لا يفوّت الفرصة علينا لمراقبة النتائج التي سيخرج معها الحصاد الانتخابي، فمن المعلوم أن الفائزين سيكونون إما من الكتل السياسية المتمكّنة سلفاً، وإما من ما يسمى بالمستقلين، ولا كلام لي عن الكتل السياسية فواقعها ومسارها معلوم، ولكن ماذا بشأن المستقلين الذين سنفترض أنهم سيتمخضون من النخب الواعية؟
فإذا ما كان النظام المنتج في مجلس النواب وفقاً للدستور هو النظام الكتلوي، فكيف سيكون عمل هؤلاء المستقلين؟ والتجربة التاريخية أظهرت بشكل واضح أن الأصوات الأحادية في مجلس النواب لم تكن مجدية بل كانت فاقدة للتأثير إلى حد كبير!
إن أمامنا أربعة افتراضات عملية عن مثل هؤلاء، فهم إما أن يبقوا على استقلالهم وعندئذ عليهم ان ينتظروا حالة الصفق بيد واحدة وهي يد جذّاء لا أثر لها من الناحية العملية في تشييد المشروع.
وإما أن يتحولوا إلى كتلة لوحدهم، وهو أمر يدعونا للتساؤل عن طبيعتهم البرامجية ومنهجهم، لأنهم بذلك إما أن يتحولوا إلى حزب كما حصل مع كتلة مستقلون في الدورات النيابية السابقة وبالتالي سيتجردون من صفة الاستقلال، وعندئذ سنرجع الى حقيقة الموقف من الأحزاب وما يجب العمل تجاهه، أو أنهم يتحولون إلى كتلة رقابية لا هدف لها في المبادرة البرامجية، وإنما هدفها هو مراقبة الأداء والبت بشأنه وفقاً لطبيعة ما يصدر من الكتل او الحكومة، أو دعنا نقول أن عملها سيكون محكوماً بما ينتجه الظرف السياسي أو الحكومي، وبالتالي ستكون هذه الكتلة ذات مهمة ظرفية، وهي في أحسن الأحوال منفعلة لا فاعلة، وأفضل الفرضيات لأمثال هؤلاء أن يتجمعوا ككتلة واحدة قبل الانتخابات تتفق على برنامج سياسي وتعمل وفقاً له، أو أن تتصدى جهة ما لإعداد برنامج لمن ينجح من أفراد مستقلين، ويتم إحتواءهم لتنفيذ هذا البرنامج. بطبيعة الحال مثل هذه الافتراضات لا تراعي عنصر الزمن ولا طبيعة الظروف التي تحيط بكل المشهد السياسي والبرلماني، ولذلك توخي النتائج العملية عليه أن يكون توخياً متواضعاً.
وإما أن يتم توزيعهم على كتلة سياسية أو أكثر لكي يكونوا في داخلها ويغيّروا من داخلها، وقد اثبتت تجربة من التحقوا بالكتل الأخرى أنهم إما عجزوا عن لعب الدور المفروض لهم، أو أنه تم امتصاصهم وتذويبهم من قبل نفس الكتل أو بميل من أنفسهم وخضعوا لطبيعة برامج هذه الكتل.
وإما أن يتحولوا إلى مشاريع بيضة القبان بين الكتل، ويتعاملوا معها بمنطق الضغط، ومع أن هذه الحالة تفترض أن عملها محدود في حدود القوانين او القرارات التي تخلق صراعاً بين الكتل فتبتدأ هذه الكتلة أو تلك للبحث عن مزيد من الأصوات فتتجه الى استعطاف هذا أو ذاك من المستقلين، أو أن يتحولوا إلى مشاريع مساومة وفي هذه وتلك ما فيها من الآلام والابتلاءات ما لا يخفى على أريب.
إن النظام البرلماني في العراق إذ يؤسس على الكتل كان من الأجدى أن يتم التعامل معه على أساس كتلة في مقابل كتلة، لا على أساس الرغبة في تقليص دور هذه الكتل من خلال حكاية المستقلين، فمع أن الإستقلال لا هوية له تجاه الوطن والمطالب والاستحقاقات، فإنه مهما كان ذا عدد، ومهما كان ذا صدق، فإنه لن يكون منتجاً من الناحية العملية في لعبة البرلمان في وضعيته الدستورية الحالية، خاصة مع الظروف الأمنية التي يشهدها البلد، والتي تجعله عرضة لضغوط كثيرة جداً، وما أسهل أن يتم تهديده بنفسه او عائلته وتوظيف العصابات السائبة لتنفيذ ذلك أو التلويح به، وما أسهل أن يهدد كي يتنحى ليأتي من بعده من يأتي مستقلاً كان أو كتلوياً، وأسوأهم حظاً من يكون وراءه في النتائج من ينتمي الى الكتلة التي لا تبالي كيف تهدر الدماء وتروّع النفوس وما أكثر النماذج على ذلك.
وخلاصة القول: ان القانون يمكن أن يوفر فرصاً متساوية لو كان يتم تنفيذه ضمن بيئة استقرت فيها منظومة الضبط المجتمعي والاداري، وحيث تنتفي في العراق فلا أقل يمكن القول بامكانية ان يعطي نتائجاً ملموسة لو اقترن بعملية تحشيد جماهيري أشبه ما تكون بالحشد المرجعي الذي استقبل الفتوى الجهادية المباركة، ومن دون ذلك فإن التفاؤل بالقانون الجديد سيكون مبالغة في غير محلها، وقد تحوّل القانون كي يكون مبرراً - والعياذ بالله - لتمكّن الفساد بأقسى صوره.
هذا ما عنّ لي أن أسطره في ضيق من الوقت وزحمة في العمل، وأملي أن يكون مفيداً في بلورة فهم أفضل للمهمات والواجبات تجاه ديننا ووطننا، والحمد لله أولاً وآخراً، وسلامه وصلاته على رسوله وآله أبداً.