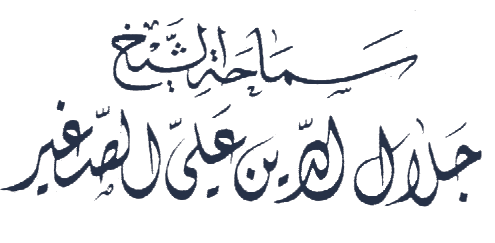أم إحسان الكريماوي (مجموعة حكيميون): شيخنا الأجل يعترض المخالفون على طول عمر الامام، وأن الإنسان لا يستطيع أن يعمّر هذا العمر الطويل، فما هو الرد على هذا الاعتراض؟ ودمتم.
الجواب: مشكلة الطول الزمني لعمر الإمام صلوات الله عليه، تارة ينظر لها من خلال طبيعة الخلقة الإنسانية، لذا فالنقاش سيتمحور في قابلية الخلية الإنسانية على البقاء مدداً طويلة أو لا؟ وأخرى يناقش من خلال التجربة البشرية التاريخية، لنجد هل أن التاريخ البشري حوى نماذج لأعمار زمنية أطول من المعدلات الطبيعية التي نألفها اليوم أم لا؟ وثالثة يناقش من خلال إمكانية تدخل الإرادة الإلهية الخالقة في إطالة عمر الإنسان مدداً أطول من المدد الطبيعية، كما نراه في تدخل هذه الإرادة في قصر هذه المدد، أو عدم وجود هذه الإمكانية؟
ولا يمكن للمرء أن يناقش بعيداً عن هذه المجالات، لأننا سنجد أن غالبية المعترضين يعتمدون على حسابات أمزجتهم أكثر من اعتمادهم على حسابات الحجة والبرهان، والمؤسف أن هذا الاعتراض في غالبية الأحيان يتم بناء على حسابات طائفية ليس إلّا، وإلا كيف يمكن أن تجيز لابن أبي حاتم الرازي أن يروي عن طريق سفيان عن رجل يقال له عبيد وكان لا يتهم بالكذب قال: رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني![1]. وهذا في زمن العباسيين، ولا تجيز لولي الله أن يكون عمره طويلاً؟
على أي حال لا أعتقد أن أحداً من المسلمين يمكن له أن يناقش في شأن إمكانية التدخل الإلهي في إطالة هذا العمر أو تقصيره بأي مقدار طال أم قصر، فالله على كل شيء قدير ولم يلزم نفسه بعدم التدخل في هذا الأمر، وبالتالي فلا مجال للتوقف عند هذه المسألة اطلاقاً، ويكفينا في هذا المجال أن الله سبحانه وتعالى أطال في عمر إبليس عليه لعائن الله كل هذا الزمن الممتد من قبل الطلب بالسجود لآدم عليه السلام وأبقاه ليوم الوقت المعلوم، ولذلك أعتقد أن النقاش يتمحور في الجانبين الأوليين.
ومن حسن الحظ أن القرآن الكريم تكفّل بعرض التجربة التاريخية البشرية في طول العمر من خلال ما أشار إليه القرآن الكريم في قصة نوح عليه السلام، إذ تحدّث القرآن بصراحة وافية عن أن التاريخ مرّت به حادثة كان فيها عمر الإنسان طويلاً بالطول الذي عرضته الآية الكريمة: { ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلّا خمسين عاماً، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون}[2]، وبمعزل عمّا إذا كان عمر نوح قد اطاله الله سبحانه وتعالى بناء على معجزة أو وفق قابلية الخلقة الإنسانية، فإن القدر المتيقن أن هذا المثال التاريخي يسمح بالقول بأن التجربة التاريخية حوت نموذج من ذلك، فما بالكم لو ضممنا إليه عمر العبد الصالح الخضر عليه السلام؟ والذي تجمع المصادر التاريخية المعنية بهذا الموضوع أنه لا زال حياً مع أن القرآن يتحدث عن وجوده في زمن نبي الله موسى عليه السلام، وماذا لو ذكرنا عمر نبي الله عيسى عليه السلام، بل ما يتحدث عنه العديد من مؤرخي القوم في شأن عمر إدريس عليه السلام وهو سابق لنوح عليه السلام ويعتقدون انه لا زال حياً.
والطريف أن غالبية كبيرة من علماء حديث أهل السنة تتحدث عن وجود الأعور الدجال في زمن رسول الله صلوات الله عليه وآله، ويشيرون إلى أن الرسول صلوات الله عليه وآله قد التقى به وزاره عدد من الصحابة كعمر بن الخطاب، وفي هذا المجال يمكن مراجعة قصة ابن صائد وهو من يقول الكثير منهم بأنه هو الأعور الدجال والذي سيظهر ضمن أشراط الساعة الكبرى في مروياتهم أي أنه في نهاية الزمن، فلقد روى القصة كل من البخاري ومسلم وأبي داود وأحمد والترمذي وابن حبان في الصحيح وعشرات غيرهم.[3]
لذلك ما من سبيل للتحاجج في المسألة التاريخية لأنها تشير إلى حصول ذلك بالتواتر، وليس بضائر أي تفسير لعمر نبي الله نوح عليه السلام، سواء قيل بمنطق الإعجاز أو قيل بمنطق الغرابة التاريخية، فنحن أمام حدث تاريخي وتنجّزه على واحد من البشر يسمح بتنجّزه على الملايين، بالرغم من أننا لا نوافق على منطق المعجزة في هذا المجال كما سيتضح عما قليل، ولكن من باب محاججة هؤلاء بما يحتجون به.
يبقى علينا أن نكتشف هل بإمكان بنية الخلية الإنسانية أن تستمر بالحياة إن لم يطرأ عليها طارئ خارجي، أو بمعنى آخر هل أن الخلية الإنسانية تحمل سر فنائها معها، بحيث أنها تكمل دورة زمنية محددة، فيتفعّل سر الفناء الذاتي فيحيلها من خلية حية إلى خلية ميتة، مما يجعل عمر الإنسان محدداً بسقف زمني محدد.
لعل من مندوحة القول بأن خالق هذا الإنسان هو الأعرف به من غيره، وهو الذي يعبّر عن مواصفات ما خلق بقوله تعالى: {أحسن كل شيء خلقه}[4] ويرينا هذا الوصف بمعزل عن أي شيء آخر أن ما خلقه الله لا يحمل سر فنائه، لأن احتواء الشيء على سر فنائه يبعد عنه هذا الحسن الذي يتحدّث عنه البارئ جلّ وعزّ، ولذلك نرى أنه ربط موت الإنسان بعامل خارجي دوماً {قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم}[5] مما يعني أن الخلية الإنسانية إن لم تتعرض لعارض خارجي فإن سبل ديمومة الحياة مكفول لها، والتعرض للعامل الخارجي يتفاوت فيه الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى في حديثه مع آدم عليه السلام فصّل في هذا الموضوع وبيّن أن الإنسان بإمكانه أن يمنع عن نفسه هذا العامل الخارجي فقال عزّ من قائل: {فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى* إن لك ألّا تجوع فيها ولا تعرى * وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى}[6] وهنا يجب أن يلفت إنتباهنا استخدام عبارة: { إن لك} وهي تعني جعل الخيار بيد آدم عليه السلام، فبيده يستطيع أن يعيش هذه الحالة، وبيده تنتفي هذه الحالة، ومع ملاحظة ان الجنة المطروحة هنا ليست جنة الخلد، لأن تلك الجنة لا تكليف فيها ولا يوجد فيها مجال لمثل إبليس فضلاً عن ان من يدخل فيها لا يخرج منها، والحديث هنا واضح فيه إبليس فيه أمر إرشادي تشريعي وفيه إخراج من الجنة وكلها لا تتناسب مع جنة الخلد، وحديث أهل البيت عليهم السلام بأنها جنة من جنان الدنيا يؤكد هذا الأمر، فعن الحسين بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جنة آدم عليه السلام؟ فقال: جنة من جنان الدنيا؛ تطلع فيها الشمس والقمر، ولو كانت من جنان الآخرة ما خرج منها أبداً.[7]
بناءاً على كل ذلك يجب أن نعود للآيات الكريمة لنتساءل عن سر ذلك، فمن المعلوم أن قابلية جسم آدم هي نفس قابلية بنيه، وما يسري عليه يسري عليهم، ومع ملاحظة أن الجوع والعري والظمأ والحرارة المُشار إليها في الآيات الكريمة كلها من العوامل الخارجية، وهذه العوامل هي ذاتها التي تعمل على قتل الخلية الإنسانية، كما تؤكد ذلك الأبحاث البيولوجية المعاصرة، فالخلية حينما تتعرض للجفاف، وحينما تتعرض لانقطاع الماء عنها، وحينما لا تتغذى، وحينما لا تحجب عن عناصر التلوث، فإن كل مقومات الحياة تكون مكفولة لها، ولكنها تموت مع هذه العوامل كلاً أو جزءاً، مما يجعل حديث الآيات الكريمة حديث عن أسرار البقاء، وليس مجرد حديث عابر جرى في لحظة تاريخية مرت ولن تعود، أو أنه غير صالح في بقية التاريخ.
والملفت للإنتباه هنا أن الله سبحانه وتعالى جعل سبب الشقاء والذي بسببه أخرج آدم من هذه الجنة، هو الحياد عن إرشادات الله تعالى والإصغاء إلى الشيطان، والشيطان هنا وإن ضرب بإبليس مثلاً، إلّا أنه عنوان لكل ضر معنوي أو مادي يلحق بالإنسان ومحيطه، وكذلك طبيعة ما يؤكل، وذلك لقوله تعالى: {ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين* فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما}[8]، والدمج ما بين الأمرين يوحي بأن السبب الرئيس للضر المادي الذي يحصل للإنسان، هو طبيعة تسرّب منظومة الضر إلى المنظومة الغذائية للإنسان، ومما لا شك فيه أن هذا الضر إن أخذناه بالمعنى البيولوجي فسيتعلّق بما يعرّض الخلية الإنسانية إلى واحدة أو أكثر من عناصر الإماتة، وهي الجفاف أو الحرارة أو التلوث الخارجي أو انعدام الغذاء، وعليه فإن طهارة قلب الإنسان مما يجعله غير قابل لوسوسة الشيطان، والتوقّي الغذائي يجعل عمر الإنسان مفتوحاً بدون قيود، ما لم يعرض إليه حادث كالقتل وما شاكل، ولا يوجد لدينا في مفهومنا القرآني أطهر ممن وصفوا بأنهم ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً وأعني بذلك أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، ومن هنا يمكن لنا أن تبين لم قال الرسول الأعظم صلوات الله عليه وآله فيما ينقله عنه الإمام الحسن عليه السلام: ما منا إلّا مقتول أو مسموم،[9] وكذا ما قاله الإمام الرضا عليه السلام: ما منا إلّا مقتول شهيد.[10]
ولو ضممنا إلى خصيصة العصمة التي تعني عدم خضوع المعصوم لوسوسة الشيطان، حالة العلم المتوافر لدى المعصوم صلوات الله عليه ومنه علم الأبدان والذي يتيح له أسرار الغذاء وطبيعته، وضممنا كل ذلك إلى حالة الغيبة والتي تعني انه سيكون في منأى عام من العوامل الخارجة عن النظام الغذائي أو المعنوي، لأنه سيكون بعيداً عن أذى الظلمة، فإننا نخلص إلى أن كل العوامل التي تؤثر في قصر حياة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف منتفية تماماً، مما يجعل الحالة الطبيعية فيه هو طول حياته بأبي وأمي، ولذلك تفصيل يمكن مراجعته في الجزء الأول من كتابنا علامات الظهور.
[1] تفسير ابن أبي حاتم 7: 2352 ح12743.
[2] سورة العنكبوت: 14.
[3] انظر على سبيل المثال: البخاري في صحيحه 7: 113 ـ 114، ومسلم في صحيحه أيضاً 8: 190 ـ 194، وأبا داود في سننه 3: 321 ـ 322، وأحمد في مسنده في مواضع كثيرة منها 3: 368، والترمذي في سننه 3: 351، وابن حبان في صحيحه 15: 187، والبزار في مسنده 9: 396، والطبراني في المعجم الأوسط 8: 242، وفي المعجم الكبير 3: 135، والداني في السنن الواردة في الفتن 6: 1191، والسيوطي في الديباج على مسلم 6: 239.
[4] سورة السجدة: 7.
[5] سورة السجدة: 11.
[6] سورة طه: 117ـ119.
[7] الكافي 3: 247 ب164 ح2.
[8] سورة الأعراف: 19ـ20.
[9] كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر: 257 ح98.
[10] من لا يحضره الفقيه 2: 585 ح3195.