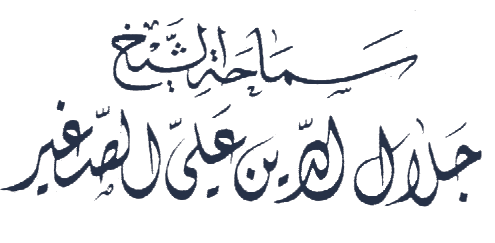أفكار بلا عواطف (5)
أفخاخ في طريق تشخيص المطلوب الحضاري
كما أننا رأينا كيف يتم الحرص على أن لا نرى واقعنا المريض بصورته الحقيقية، ولأن عدونا يعرف أن بعضنا سيفلت من هذه الخديعة، ولذلك فإن ذلك الحرص سيستمر ايرافقنا في عملية تشخيص المطلوب.
وعليه فإننا لا نرى عملية تشخيص المطلوب مهمة سهلة كما قد يعدّها البعض، بل هي الأكثر تعقيداً من نوعها، لأن من أجهد نفسه في أن يخدعنا في تشخيص أمراضنا وعللنا، سيجهد نفسه أكثر في أن يبعدنا عن العثور على مطلوبنا الحقيقي، وإن كان الإنسان مبتلى بكثرة الأفخاخ المعنوية والبشرية والاجتماعة فيما حوله، فلا شك ان هذه الأفخاخ لا تريده أن يصل إلى هذا المطلوب.
إن هذه الأفخاخ وببساطة تستهدف دوماً غشّ بصيرته وخداع وعيه فيما يطلب، لإن عادة أصحاب هذه الأفخاخ يحرصون على أن يفقد الرؤية فيضيع المطلوب الحقيقي له ليستبدله بمطلوب يتصوّر أن مناه فيه، بينما في واقع الحال يكون هذا المطلوب هو بالضبط المذبح الذي سوف تنحر فيه المزيد من آماله وطموحاته، غاية ما هنالك أن هذا المنحر مزيّن بأبهى الحلل ومغطى بأنفس الأوشحة ومعلب بأثمن العلب، ولذلك عليه أن ينقاد إلى جماله، بالرغم من أن حقيقته هو منحر له ولآماله ليس إلّا، وخذ مثلاً على ذلك ما جرى في العراق في قصة الإصلاح الزراعي ومحاربة الاقطاع، فقد كان الجنوب والوسط العراقي في الخمسينات من القرن الماضي عامراً بالأرض الزراعية، وتحت شعارات اليسار المغطى بريطانيا ولربما طائفياً جرى في أواخر الخمسينات وفي العهد الجمهوري تسويق شعار الإصلاح الزراعي، وفرحت الناس لهذه الخطوة الجبارة التي ستخلصهم من الإقطاع والملّاكين، وتعطيهم دفقة من الرفاه لم يكونوا ليحلموا بها، وسرعان ما امتدت يد الدولة تأخذ من الملّاكين أراضيهم وتوزيعها على الفلاحين بواقع يتراوح بين الخمسين والمائة وخمسين دونما لكل واحد من هؤلاء، وفي غمرة الفرحة العامرة انطلقت آمال كبرى في داخل نفوس الفلاحين بالخير القادم، فهؤلاء حسبوا أن الأرض حينما وضعت بأيديهم ستعطيهم ما كانت تعطيه للملّاكين، وما حسبوا أن الزراعة ليست الأرض والفلاح فقط، بل هذه وكل المستلزمات المالية التي تحتاجها عملية الحراثة والبذار والسماد والمكافحة للآفات الزراعية والري والحصاد وما إلى ذلك، وما مرت إلا شهراً او شهرين حتى وجدنا الفلاح يعاني من زحف الإفلاس على جيبه فلا هو قادر على فلاحة الأرض، ولا هو يحظى بما كان يؤمنه من لقمة العيش من عمله مع الملّاكين، ولهذا كان القرار المرير للهجرة من الريف إلى المدن الكبرى، ومنها بغداد التي كانت الحكومة قد أطبقت نسيج الفخ حينما خصصت أراضي مدينة الثورة (الصدر حالياً) يومذاك، ومن هذا القرار كانت الأرض تغادر خصبها بالتدريج، فيما كانت الدولة تشبك نسيج سخرة المواطنين لمصلحتها عبر التجنيد وأعمال السخرة الأخرى، وعليه هنا يمكننا أن نلاحظ أحلام الرفاه المطلوبة كيف تحولت إلى أنياب ومخالب ضارية للفقر والاستعباد!!.
إن الخداع الذي يواجهه الناس صنفان، صنف يصنعه الإنسان بنفسه لغرور أو جهل أو أحد العوامل النفسية التي تشتعل بها نفسه في وقت تفعيل الإرادة، وصنف ينقاد إليه بوعيه، ولكن هذا الوعي مفتعل لديه ومصنوع له، وليس هو الوعي الحقيقي المبتنى على أساس الرؤية السليمة والبصيرة النافذة، ولئن كانت العوامل المعنوية غير المسيطر عليها وقدرتها على خديعة الإنسان أسهل في الكشف، وبالتالي فإن إمكان تلافي مشاكلها يبقى سهلاً، لأن قرار الانصياع لهذه الخديعة يبقى ذاتياً، وبالتالي يبقى الإنسان يملك قدرة التحرر منه متى ما أراد وضرائبه عادة ما تكون من الصنف الذي يمكن جبرانه، ولكن مشكلة الأمم الحقيقية هي في الصنف الثاني من الخداع الذي يتم فيه غش وعيه ليحمل جهلاً مركباً يسميه علماً، وثقافة مشوهة يسميها تنوّراً، وذوقاً سيئاً يسميه تحضّراً، ودعوني أضرب مثالاً عملياً على أصناف هذا الخداع، فمن المعروف أن تجارة التجميل تعدّ الآن واحدة من التجارات الأكثر تداولاً في العالم، وهي بدورها تحرك قطاعاً كبيراً من أسواق الإعلان والتسويق والنقل وما إلى ذلك وتستهلك قطاعات إدارية وتقنية هائلة، وفي كل ذلك أمولاً خيالية، والمرأة يمكن في الكثير من الأحيان أن تضغط على نفسها وجيبها من أجل أن تقتني هذه الحاجة أو تلك من مواد هذه التجارة، ويساعدها الرجل كثيراً على ذلك فهو يطلب المرأة المزينة والمتلونة بالتلاوين التي تستهويه، ووسائل الإعلان تغري الجميع بالإقبال على ذلك، ولكن لو تأمّلنا دقيقاً في الصورة سنجد بوضوح أن الطرفان يمارسان خديعة ذاتية تستهويهما، وفي داخل هذا الإقبال نجد خيوط الخديعة تتخفى وسط الألوان البراقة والأنسجة الحريرية المستخدمة في عملية زيغ البصر والذوق، فالرجل حينما يطلب المرأة المتلونة بألوان غير ألوانها يريد في الواقع أن يرى سراباً ولا يريد أن يرى حقيقة المرأة، بل هو يرريد ما يثري نهمه الغريزي والمزاجي، والمرأة التي تلوّن نفسها تعرف جيداً أنها تبدي صورة لا حقيقة لها، وتريد من الرجل أن يصدق هذه الصورة لا صورتها الحقيقية، مع أن المرأة تطالب باستمرار بأن يكون الرجل صريحاً معها، ولكن هي ببساطة لا تريده صريحاً حينما تلهث وراء هذه الألوان، والرجل الذي يطالب المراة دوماً أن تكون صادقة معه، لا يريدها صادقة لأنه يلهث وراء ألوانها المزيفة ولا يطلب منها أن تكون كما هي، وأمام هذا المثل نجد الخديعة ذاتية واجتماعية في وقت واحد، ذاتية لأن الخداع يمارسه الفرد بنفسه ولغيره، واجتماعية لأن هذه الخديعة الذاتية هي نموذج لخديعة عامة يمارسها غالبية الناس فتتحرك اقتصاديات زائفة كبرى لتستنزف الجيوب ومن بعدها الاقتصاد التنموي بشكل ترفي لا علاقة له بأي حالة تنموية للذات أو للمجتمع، ومن هذه قس الكثير من الخدع التي نمارسها جميعاً بأنفسنا أو بمجتمعنا بالرغم من حديثنا بأننا نطلب رقي المجتمع!!
بطبيعة الحال قد لا يرى بعض الناس أن هذا الأمر ليس بالمستهول الفظيع، بل لا بأس من بقائه، لأن جمال المرأة بحد ذاته مطلوب لو كان الأمر يتعلق بهذا المثال، وبالعادة فإن هذا الصنف يفكر بالمرأة كشكل وكجسد وكغريزة، وقد لا تجد المرأة بأس في ذلك لأن طبيعتها تقتضي منها أن تتجمل للرجل، وفي عقيدتي أن ذلك ناجم من سوء تقدير لوعينا الذاتي، فهل المرأة هي هذه الغريزة أو هذه اللوحة التي يجب أن نمتّع بها أعيننا وأنفسنا، أم أن المرأة كيان أرفع من ذلك بكثير؟ وأن هذا الشكل والغريزة هو جزء من حاجة فطرية موضوعة لأغراض أنبل من كون المرأة وعاء للجنس ليس إلّا.
لا شك أنني لست في صدد مناقشة تفاصيل ذلك في هذه المجال، ولكن مما لا شك فيه أننا بحاجة ماسة لمراجعات كثيرة في تراكماتنا الثقافية لكي نحدد لوعينا الذاتي مساراً سليماً، لأن وعينا لذاتنا هو من الشروط الأساسية لأي نهضة نطلبها، ومن دونها لا يمكننا إلا أن نكون مجرد ركام كمّي في مستودع البشرية هذا.
وبالعودة لمثالنا السابق لو قدّر أن يصيبنا هذا المثال بعضنا بدوار لأن من شأن التخلص من أعباء هذا الأمر يستلزم اعادة شاملة في تركيبتنا النفسية، وهذه بدورها تحتاج إلى إعادة أشمل لمنظومتنا الثقافية، وإلى إعادة تقييم لمعايير الجمال الفلسفية لدينا وقيمه، ومنه لطبيعة فلسفتنا ونظمنا الأخلاقية، ومن هذه لنظمنا المعرفية ومناهجها، مما يعني أن ضرائب الخروج من هذا الدوار ستكون باهضة الكلفة.
الأمر الذي يجعلنا أمام مفترق طرق حاسم فإما أن نأخذ طريق الحلول السهلة التي عادة ما لا تنظر إلى المشكلة بحجمها الحقيقي، وإنما تحاول أن تتجاهلها ومن ثم قد تدعونا للإسترخاء والترهل لأن هذه المشكلة لا وجود لها إلّا في عقول المنظّرين الاستراتيجيين، وهذه الحلول لها مسوغات كثيرة منها أن من أوجدها لا زال يمسك بقدرات هائلة للتأثير على الوعي نتيجة لوسائل الاتصال الجمعي الممسوكة بإحكام بيديه، ولأن نجاحه في التأثير الثقافي سار بشوط بعيد في أغوارنا الاجتماعية والثقافية، حتى عاد الكثيرون لا يقبلون التحدث عن ذلك بصيغة العلة والمرض، ومنها لأن الطريق السهلة تلقى ترحيبا من النفس المتعبة حتى لو كانت الأثمان المترتبة عليها باهظة الكلفة لاحقاً.
أو أن نختار الحلول الجدية، ولو فعلنا ذلك فإننا سنكون بحاجة جادة لمنظومة نقدية شاملة تشمل الذات والمجتمع والبنى المعرفية وتشخص طبيعة ما نمتلك من مقومات النهوض، وما نفتقد منها، فليس كل ما لدينا خطأ كما أنه ليس كل ما لدينا صحيح، وبنفس القدر ليس كل ما أعلّ أوضاعنا وأسقمها ناجم من تقصير، كما أنه ليس ناجم من قصور فقط، إن الرؤية الواقعية لحقيقة ما لدينا من دون ألوان اضافية ومن دون إضافات تجميلية كفيلة لتسهل لنا عملية التشخيص لما نطلب، لأننا سنواجه في عملية البحث عما نطلب مناهج متعددة قسم منها هي الأفخاخ المنصوبة لنا والتي تم إكساءها بأبهى الحلل وأكثرها جمالاً، وقسم منها قريبة الأجل قليلة النفع، وقسم منها بعيد الأجل ولكنه كثير النفع، وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال أن نعرف هويتنا وما نختزنه في ذاتنا وواقعنا بشكل دقيق.
وللحديث تتمة تأتي لاحقاً إن شاء الله.